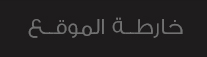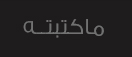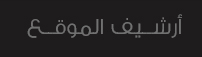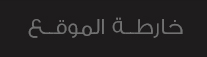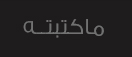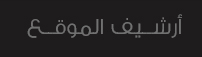|
“المادة”..
صياغة حداثية عن محاولات الخلود والبقاء بين جسدين
خالد عبد العزيز
بعد أن أفنى الإمبراطور الصيني “تشين شي هوانغ” القسط
الأكبر من حياته في توحيد الممالك الصينية المتناحرة، انطلق في بحث دؤوب
عما يجعل عمره الزمني يمتد بلا نهاية، فأصبحت حياته فريسة لينة للعقاقير
والتعاويذ السحرية، فاستحوذت طواعية على مسارات جسده، فأسلم مقاديره لمصيره
المحتوم المعلوم سلفا، وحينها أصبح حلم الخلود سرابا منثورا.
قد تبدو هذه المقدمة خارجة عن سياق التناول النقدي، لفيلم
إشكالي وجدلي، هو الفيلم البريطاني الفرنسي “المادة”
(The Substance)،
الذي كتبته وأخرجته الفرنسية “كورالي فارغايت” (2024)، وهو ثاني تجاربها
الروائية الطويلة، وقد نال جائزة أفضل سيناريو في الدورة الـ77 من مهرجان
كان السينمائي، ورُشح لخمس جوائز أوسكار.
لكن بنظرة بانورامية على فكرة الفيلم العامة، نجد أنها
-بطريقة أو بأخرى- تبدو مماثلة لتلك الحكاية التاريخية التي ذكرنا، فالبحث
عن وهم الخلود والبقاء، يشكل العصب الأساسي لفيلمنا.
عقار الشباب لامرأة متقاعدة
تدور الأحداث حول “إليزابيث سباركل” (الممثلة الأمريكية
ديمي مور)، وهي نجمة ومقدمة برامج استعراضية، انحسرت عنها أضواء الشهرة،
بعد أن أحالتها الشبكة الإعلامية التي تعمل فيها إلى التقاعد المبكر، على
إثر بلوغها سن الخمسين، وبطريق الصدفة تعثر على عقار طبي، ينسخ من باطنها
نسخة أحدث عمرا وأكثر شبابا.
قد تظن في أول وهلة أن هوية الفيلم الفكرية مكررة، أو سبق
توليفها في سياقات مشابهة، لكن الحقيقة أن العكس هو الصحيح تماما، فمع أن
الجدار الفكري الواضح والصريح للسرد هو التناول المباشر لسراب البحث عن
الخلود، فإن هذه الفكرة ما هي إلا بوابة افتراضية، مفتتح ومدخل لما هو أعمق.
فالصراع مع الزمن يشكل جدارا فكريا موازيا، وهذا النزاع
المستعر يُستدعى هنا في مستوى أكثر اشتباكا مع الواقع، فتتصاعد من بين طيات
السرد نبرة انتقادية منددة بالإجراءات التجميلية، التي تسهم في تسليع الجسد
الإنساني.
وبناء على ما سبق، يمكن القول إننا أمام فيلم مثقل بالهموم
والرؤى التي تحتاج بلا شك إلى سرد سينمائي وبصري، يلائم هذا الطرح الفكري
الدسم، وعندئذ يصبح مشروعا وواجبا السؤال عن أسلوبية التناول والتعبير.
تجربة علمية على بيضة تفقس شبيهتها
لا يتأخر السرد في تقديم دعائم إجابته، ففي المشاهد الأولى
من الفيلم نرى تجربة علمية على بيضة ما، تُحقن بمادة طبية لا يدرك كنهها،
وما هي إلا ثوان معدودة وتخرج منها نسخة أخرى، مماثلة لها في الحجم واللون.
وفي المشهد الموالي، نرى من زاوية علوية مراحل الإعداد
والبناء لنجمة هوليود الأرضية باسم “إليزابيث سبراكل”، وتتوالى اللقطات
التي تكشف تصاعد منحنى النجومية والشهرة وهبوطه، وما يرافق هذه المعادلة،
من تأثير حقيقي على الجدارية الأرضية، فتصاب بالوهن والتشقق.
وهكذا اختار السرد أن يبدأ حكايته بهذا التتابع، الذي قد لا
يوحي بأنه يرتبط بصلة محددة بنطاق الفيلم، لكن ما يثير الدهشة والتأمل حقا،
هو أن هذا المفتتح يفصح ببلاغته الموجزة، عن مضمون الفيلم وفكرته، بالتوازي
مع كشفه المتواري عما سنراه لاحقا من أحداث، وكأننا أمام بلورة سحرية تزيح
الستار عن المستقبل.
نسيج بين أرذل العمر وشرخ الشباب
نسج السيناريو أحداثه وفق إطار درامي خيالي، لا يخلو من
الجرعات المكثفة للرعب النفسي، وتدور دفة الحكي استنادا على مبدأ الأقواس
الدرامية، فالبداية مع القوس الافتتاحي، الذي ينطلق على مضمار السرد، مع
مشاهد إنشاء النجمة الأرضية من “إليزابيث”.
وينغلق القوس المقابل كذلك من ذات المكان، وما بين هذا
الإطار وذاك يقبع النسيج السردي، المتشعب الاتجاهات والأفكار، ومن ثم لا
يلجأ السيناريو إلى الالتواءات الدرامية، ولا إضافات أدنى تعرجات زمنية أو
سردية، بل يعمد في بنيانه على خطية الحكي، الذي يحتوي هيكله على الفصول
الدرامية المعتادة، التمهيد المبدئي، ثم الوسط أو صلب الحكاية المتضمن
للذروة المنتظرة، ثم الوصول إلى الفصل الثالث الختامي للقصة.
وبذلك تتساوى كفتا الميزان بين حداثية الأسلوب الفني
والإخراجي من ناحية، ونمطية البنية الدرامية على الجهة الأخرى، التي تعقد
على مدى زمن الفيلم (نحو 140 دقيقة) مقارنة بين عالمين، أحدهما بلغ من
اكتمال العمر أرذله، أما الجديد الناشئ فما زال ينبش عن مساحته المستحقة في
الوجود.
صراع نسخة النضوج ونسخة الصبا
سعيا لمعاودة طرق أبواب الشهرة، تتناول “إليزابيث” المحلول
الطبي، فيتفاعل تلقائيا مع الحمض النووي، وينشئ ذاتيا نسخة إنسانية بالغة
الكمال من رحم النسخة الأولى، وتلك معارضة فنية لرواية “دكتور جيكل ومستر
هايد” للكاتب الأسكتلندي “روبرت لويس ستيفنسون”.
نصبح أمام نسختين مكتملتي الروح والإحساس، تمارس كل منهما
حق الحياة مدة 7 أيام، تتبادلها مع الأخرى، وفق موعد معلوم ثابت لا يتغير،
وذلك حفاظا على تفاعلات التوازن الوجودي بينهما.
ثم يدخلنا السرد في رحلة شيقة، قوامها التضاد الشكلي، مع
الإبقاء على معادلات التجانس الداخلي، وهكذا تنطلق محركات الحكي بين رحى
عالمين، لكل منهما بنيانه وأركانه، التي يبدو أنها لا تتقاطع مع الآخر، لكن
الواقع أن كلا منهما يشتبك مع الآخر.
فإذا كانت الفكرة الفلسفية المتداولة عن احتواء النفس
البشرية على طرفي الخيط من الخير والشر، فإن المعالجة الدرامية هنا تبدو
متقاربة بدرجة أو بأخرى من هذا الطرح الفكري، لكن بدلالات أكثر توافقا مع
البيئة العامة للأحداث، التي تعني برصد مواطن الاختلاف بين هذا العالم
الناضج، وما يماثله على الناحية الأخرى من عالم ناشئ حديث الولادة.
وحينها يمكن أن نلاحظ تباينات جوهرية بين هذا العالم وذاك،
فيخلق السرد خطا دراميا منفصلا لكل شخصية عن الأخرى، أما البداية فهي مع
“إليزابيث”، التي تطالعنا في حالات الوجوم والخوف الفطري الدائم من انكشاف
حيلتها، بجانب نوبات الهلع عند اكتشاف التطورات المتلاحقة على جسدها، الذي
تزداد إصابته بالوهن والكبر، مع كل غفوة تبادلية مع الكائن الجديد.
أما النسخة المعدلة الحديثة التي تسمى “سو” (الممثلة
الأمريكية مارغريت كوالي)، فإن حياتها تشهد نموا مطردا نحو الشهرة
والنجومية، بعد أن بسطت سيطرتها على البرنامج الاستعراضي، الذي كانت تقدمه
نصفها الآخر “إليزابيث”.
وبهذا التبادل بين النسختين، يمكن الإمساك بملامح المقارنة
الواضحة والمطمورة في نفس الآن، بين مراحل العمر المتباينة، أو بمعنى أكثر
رحابة، بين بريق الشباب، وخفوت الكِبر.
الأصل والفرع
بعد أن اكتمل الفصل الأول بقذائفه التمهيدية الكاشفة عن
أزمة البطلة النفسية والوجودية، يصحبنا الفيلم شيئا فشيئا إلى الفصل الثاني
من الحكاية، ومن أجل قراءة أوسع وأشمل، يمكن إحالة العلاقة بين “إليزابيث”
و”سو” إلى نموذج العلاقة بين الكائن الطفيلي والجسد المضيف، ترى من منهما
يتغدى ويقتات على الآخر؟
ومع تصاعد شهرة “سو” لا ترتوي من حصتها المقررة من الأيام
السبعة، وتحت ضغط الرغبة في البقاء داخل الحيز الوجودي أطول فترة ممكنة،
تلجأ إلى اختلاس كميات أكبر من سائل الحياة المدمج داخل جسد الأصل
“إليزابيث”.
لكن ما عجزت هي عن الوصول إلى صيغة تفاهمية بشأنه، أنه كلما
ازداد الاستهلاك ارتد ذلك عكسيا على النسخة المقابلة، فتفقد تدريجيا مع
مرور الوقت كل صلتها بالحياة الواقعية.
ولتستقيم مسارات العيش بينهما، لا بد أن تتساوى كفتا
الميزان، وهذا ما يشكل عائقا ومانعا جوهريا، فالحق في الوجود مكفول لهما،
لكن إحداهما يطغى إقبالها نحو ملذات الحياة على الأخرى.
هنا الفرع “سو”، يستلهم سوائل الحياة من الأصل “إليزابيث”،
وهكذا في متوالية دائرية، لا تبدو لخطوطها نهاية، مما يشكل لمحة -وإن
يسيرة- عن الصراع الدرامي للفيلم، فالصراع هنا بين العالمين، بين الأحدث
والأقدم، أو في رؤية أخرى بين الأصل والفرع، أما الحقيقة فهي أن كلا منهما
ليس إلا انعكاسا للآخر.
فرغبات النسخة الجديدة وأفعالها وتحققها المهني، هي أحلام
سابقة في عقل الأولى، ولذلك تصبح أفعال الثانية ترجمة حرفية، واستعادة
لمشاعر وتطلعات النسخة الأقدم، فكل منهما يقتات على الآخر، مع أنه ظاهريا
قد يبدو عكس ذلك.
وحينها يمكن استنباط المعنى الكامن في الجملة التحذيرية
المرافقة للعقار الطبي، “تذكّرا، أنتما نسخة واحدة لا اثنتان”، فكل منهما
امتداد للأخرى واستكمال لها، ولذلك تتضح دلالة تراجع “إليزابيث” عن قرارها
السابق بالتخلص من “سو”، حتى تكمل تحقيق حلمهما بتقديم الحفل الفني لنهاية
العام.
وهكذا يستمر الصراع بين الأصل والفرع، تُرى هل سيصل أحدهما
إلى مرفأ الأمان والاستسلام بقوانين اللحظة الراهنة؟ أم أن تلك الدوامة
السيزيفية ستواصل إبحارها بلا نهاية؟
مقصلة الزمن.. قوة عاتية تفسد أحلام الخلود
للإجابة على السؤال السابق، لا بد أن يُستدعى سؤال آخر من
قائمة الانتظار؛ ألا وهو ما الدوافع الحقيقية التي أوصلت بطلتنا إلى نسخ
شخصية موازية لها؟
وحينها يمكننا عبر ممارسة حق الجواب على السؤال اللاحق، أن
نصل إلى إجابة يقينية على السؤال الأساسي، وبالعودة إلى جوهر الحكاية
ذاتها، سنجد ضالتنا بين سطور السرد.
فالرغبة في البقاء تحت أضواء الشهرة، ليس السبب الوحيد
الراسخ اليقين، لكن ما يكمن وراء هذه المحاولات يقع تحت طائلة التشبث حتى
الرمق الأخير بأهداب الحياة.
يحيلنا هذا الإصرار إلى قراءة موازية أكثر اتساعا للصراع
الدرامي، الذي يمكن حينها تأويله إلى صراع الإنسان ضد قوى أعتى وأشد بأسا
كالزمن، الذي لا يفرق في تأثيرات تدفقه واندفاعه للأمام بين إنسان وآخر،
فالجميع سواسية أمام سلطان رياح التبدل والتغير، التي أصابت “إليزابيث” وهي
غافلة تظن أن نصال الزمن الحامية لن تقترب من وهج شهرتها.
“الوقت
يتحرك ببطء، لكنه يمر مسرعا”
يمكن القول إن مفتاح قراءة الفيلم والوصول إلى مدلوله، يقع
بين أسوار مقولة الكاتبة الأمريكية “آليس ووكر” عن الزمن وإيقاعه المتسارع
“الوقت يتحرك ببطء، لكنه يمر مسرعا”.
فالزمن الراكض باندفاع، يمثل عدو بطلتنا الأول، وهي تحسب في
لحظة منفلتة من الوقت أنها هزمت هذا الخصم العتيد، لكنه دوما لديه ما يكفي
ويفيض من الأساليب المراوغة للإمساك بفرائسه، وإنزال النكسات المفاجئة
بأوهام أحلامهم.
وليكتمل السياق التعبيري عن الفكرة العامة، ينسج السيناريو
سرديته، اعتمادا على عدالة توزيع أدوار اللعب بين “إليزابيث” و”سو”،
ويطالعنا بينهما “هارفي” (الممثل الأمريكي دينيس كويد) مدير القناة
التلفزيونية، التي تبث برنامج إليزابيث سابقا وسو حاليا.
رسم السرد شخصية “هارفي” أقرب إلى الكاريكاتورية منها إلى
العالم الواقعي، فيبدو بنمط معيشته الشرهة للحياة بكل ما بها من فرائض
دنيوية، عاملا مساعدا في اكتمال وقائع مأساة بطلتنا، سواء توفرت القصدية
المباشرة أو لا.
وقد ساهمت مشاهده المعتمدة في صياغتها البصرية على زوايا
مقربة، تكاد تلتهم تعبيرات الوجه، استكمالا للتوصيف المثالي للعالم الذي
تدور فيه الأحداث، ليبدو يحمل مزيجا خاصا من الواقعية الصريحة بما تشي به
من دلالات، والكابوسية الكافكاوية بما تحمله من سوداوية.
ترهلات وشحوم زائدة في خاتمة الفيلم
يواصل السرد الفيلمي تقدمه نحو الذروة المنتظرة، التي تنطلق
شرارتها مع حلول الشق الأخير من الفصل الثاني، فيرتفع منسوب أنانية “سو”
إلى معدلات غير مسبوقة، تستحوذ فيه على حصة مضاعفة من الأيام، ثم تؤثر
تلقائيا على النسخة الأولى “إليزابيث”، التي تفقد كل ما يثبت صلتها
بالنموذج والهيكل البشري، فتتحول إلى مسخ فاقد لأدنى معالم الإنسانية.
ولا شك أن فنان الماكياج الفرنسي “بيير أوليفير بيريسن” بذل
جهدا خلاقا في تصميم هذا التعديل على الممثلة “ديمي مور”، لتبدو عناصر
الفيلم الفنية -كشريط الصورة والتكوين وزوايا الكاميرا وحركاتها- مؤلفة
جيدا، وتنجح بجدارة في خلق أسلوب صادم وجذاب في نفس الآن، ولا يؤدي إلى
إحداث الصدمة لدى المتلقي فحسب، بل يبعث على التوتر كذلك طوال مدة العرض
السينمائي.
وهذا يحيلنا بالتأكيد إلى ما شاب الفصل الثالث من ترهل سردي
واضح، والمبالغة التي أصابت السياق العام بالوهن المؤقت، وتحديدا عند
التعبير عما آلت إليه الشخصية.
لكن هذا الطول النسبي في مشاهد الختام، لا ينفي ولا يقلل
قوة الفيلم وجودته الفنية، وقدرة الإخراج وحرفيته، فهو يستحق التحية
والثناء على أسلوبه المبتكر في المعالجة والتناول، وكذلك على نطاق إدارة
الممثلين، وتحديدا “ديمي مور” التي بلغت هذا العام عامها الـ62، فبدت كأنها
تجسد قصتها الذاتية.
يتلاقى الطرح الفكري مع الهيئة الشكلية للفيلم، ويقف كل
منهما على قدم المساواة من الآخر، مما يجعل الفيلم يصمد زمنا في غياهب
الذاكرة، فالقدرة على المكوث في ذائقة المتلقي، هي ما تثبت نجاح العمل
الإبداعي من عدمه، والأهم هو القدرة على طرق المثير من الأفكار والتأملات،
ولا أبلغ من أمنيات الاستمرار والخلود، لتصبح هي المادة الفعالة للبحث
والفكر.
وكم من أفكار أقضّت مضاجع أصحابها! |