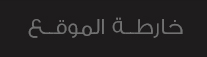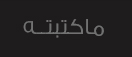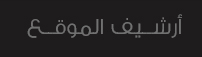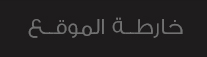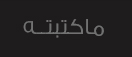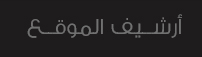|
مخرجة وكاتبة سعودية، تحوّل مسار حياتها من الترجمة والنقد
إلى السيناريو والإخراج. أخلصت للمهنة التي اختارتها، فاختيرت بين 101
امرأة مؤثّرة في صناعة السينما
العربية.
لهناء عبد الله العمير تجربة وتطوّر ملموس، وإنْ متمهّلاً.
كأنّها تُخطّط لمستقبلها. تمتلك طموحات مختلفة في الكتابة في قضايا المرأة،
كما في قضايا تاريخية ومجتمعية. تنتهج أسلوباً إخراجياً يكشف عن رغبة في
جذب المُشاهد، كما في الأعمال البوليسية أو التي يكتنفها الغموض. كتبت
أعمالاً لمخرجين آخرين.
لها سيناريو فيلم قصير بعنوان "هدف"، الفائز بالنخلة الفضية
لأفضل سيناريو في "مسابقة أفلام السعودية" عام 2008. في المسابقة نفسها،
فاز فيلمها القصير "شكو" بجائزة النخلة الذهبية عام 2015. عرض "أغنية
البجعة" (2019) لأول مرّة في "مهرجان برلين السينمائي 2019". أنتجت لها
"نتفليكس" مسلسل "وساوس" (2021). لديها سيناريوهات أعمال تُنفَّذ حالياً.
كما فازت بمنح داعمة للإنتاج لـ"شرشف" و"الرقص على حافة السيل".
بمناسبة مشاركتها في لجنة الدورة الـ12 (4 ـ 10 أكتوبر/
تشرين الأول 2024) لـ"مهرجان
وهران الدولي للفيلم العربي"،
حاورتها "العربي الجديد".
تمارسين أنماطاً عدّة من التعبير الإبداعي في السينما
والتلفزيون. لماذا اخترت إخراج المسلسلات؟ ألا تخشين أنْ تؤثّر لغة
التلفزيون على مستوى فنية لغتك السينمائية وجماليتها؟
أكيد لدي قلق كبير، لذا أحرص على أنْ تكون مرجعيتي
سينمائية. أُخرج مسلسلات لأنّي لا أحبّ الابتعاد عن السرد البصري. الأفلام
تتطلّب وقتاً طويلاً لتُنفَّذ. المسلسلات أسرع، وأحياناً تتوفّر لمن
يُخرجها إمكانات لا تُتاح له في السينما. حين أشتاق إلى الإخراج، خاصة أنّ
عروض المسلسلات دائمة، أقبل ما يتوافق منها مع ما أحبّ. كذلك، هناك قصص
سعودية كثيرة لم تُرو، وشخصيات نسائية لم نرها في التلفزيون. هذا عامل
يجذبني إلى التلفزيون، خاصة مع وجود منصات ومسلسلات قصيرة. اقترب العالمان
أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت اللغة السينمائية أكثر حضوراً في المسلسلات.
أحبّ اختبار أشكال القَصّ المختلفة. جرّبت المسرح أيضاً.
أعتقد أنّ كلّ مجال فني يُمكن أنْ يضيف للفنان، طالما أنّه يعي الاختلافات.
الانتقال من الفيلم
القصير إلى
الطويل تأخّر قليلاً. كلّ تجاربك الطويلة إلى الآن لا تزال تحت التنفيذ. هل
السبب انشغالك بالعمل للتلفزيون؟
لا. ربما لأنّي بدأت بمشاريع سينمائية طويلة تستلزم متطلبات
غير متاحة أو متوفّرة في المشهد حالياً. هناك نصوص تستحق وقتاً للنضج. ليس
الهدف إخراج فيلم طويل فقط، بل الفيلم الذي أشعر برغبة في إخراجه. هل
الظروف مُهيّأه له، أمْ لا.
لديك مشروع ضخم ومُميّز. حضرت شخصياً عرضاً له في "مهرجان
مالمو". استمتعت بتقديم مشوّق للسيناريست والمنتج المصري حسام علوان. أنتِ
قلتِ، بعد اختياره في معمل "البحر الأحمر" في المشاريع السعودية الستة،
التالي: "بعد سنتين من العمل الدؤوب، كانت الخطوة الرسمية الأولى إلى إنتاج
فيلم "مواسم الحب والحرب"، المقتبس من رواية "غوّاصو الأحقاف"، رفقة
الكاتبة والمنتجة سهى سمير". هذا المشروع نال جائزة في مالمو، لكنّ عنوانه
بات "الرقص على حافة السيل". لماذا؟
لأنّ السيناريو مرّ بمرحلة من التطوير أُلغِيَ فيها خطّ
الحرب وتعمّق خط الحب، والتركيز على أجزاء معينة من القصة. لذا، بعد كلّ ما
تغيّر، لم يعد العنوان مناسباً. حتى "الرقص على حافة السيل" عنوان مبدئي.
مع تطوير النص وتعديله، وصولاً إلى النسخة النهائية والتصوير، ربما يفرض
عنوان آخر نفسه.
لماذا تأخّر إنجازه؟
إنّه في مرحلة التطوير. ينتمي إلى حقبة قديمة، ما يتطلّب
وقتاً طويلاً من التحضير، كما يحتاج إلى ميزانية أعلى مما يُنتج حالياً.
لكنّه يسير بثبات، وإنْ بخطوات بطيئة.
ماذا يُمثّل لك التاريخ، فالفيلم يستند إلى رواية
تاريخية؟
الفترة التاريخية التي يتناولها الفيلم مهمّة جداً: ما قبل
توحيد المملكة، وما قبل النفط. كانت الحياة مختلفة تماماً، رغم كلّ هذا،
تبدو البطلة في تفكيرها أقرب مما نتخيّل ونتوقّع. لم يحدث أنْ سرد
السعوديون قصص أجدادهم وجداتهم، وهم على نقيض الصُوَر النمطية المتخيّلة
عنهم. لذا، منذ قرأت الرواية أحببتها. كنت أراها صُوراً، وسأظلّ أحلم بها
إلى أنْ أراها على الشاشة.
هناك أيضاً "جحيم العابرين"، الرواية الأكثر مبيعاً لأسامة
المسلم، التي تعملين على تحويلها إلى فيلم سينمائي تُنتجه
MBC.
إلى أي مرحلة من العمل وصلت؟ هل يشاركك أحد في الكتابة؟
إنّها مرحلة التجهيز للإنتاج. السيناريو للروائي أسامة
المسلم نفسه. يُفترض بنا البدء بالتصوير منتصف العام الحالي.
لك تجربة وحيدة مع الوثائقي، "بعيداً عن الكلام"؟ أكانت
وليدة الصدفة؟ ربما لأنّك تُفضّلين الروائي عليها؟
التجربة جميلة، تمنّيت أنْ تتكرّر، لأنّ هناك مساحات سردية
واسعة في الوثائقي. لكنْ، ما جعل الأمر صعباً خوف كثيرين من الكاميرا في
البداية. لديّ أكثر من فكرة، لكنها وُئدت في مهدها، لأنّ النساء اللواتي
وددت مقابلتهن رفضن التصوير، فاتّجهت إلى الروائي. الآن، تغيّر الوضع
كثيراً، فالكاميرا أصبحت بمتناول الجميع، ودخلت البيوت، واخترقت المساحات
الخاصة، واتّسع الفضاء العام بشكل كبير، فاعتاد الجميعُ الظهورَ على
الشاشات والتصوير.
في الفترة كلّها بين الإحجام والقبول، ابتعدتُ عن الوثائقي.
مع ذلك، إذا عثرت على موضوع يستحق، ربما أعود إليه.
أيُمكنك إخراج عمل من دون المشاركة في كتابته؟
تعمّدت خوض هذه التجربة لأرى نفسي مخرجة فقط. دائماً أحذّر
مَنْ يعمل معي أنّي ألعب بالنص، لكنْ يهمّني جداً أنْ أتّفق مع الكاتب
عليه. هناك قصص في كلّ مكان، وإذا أحسست بقصة، وبدأت تتشكّل كصُور في ذهني،
أُقدم عليها.
أخرجت حلقات من المسلسل الكوميدي "منع التجول" عن فترة
كورونا. الطرح ساخرٌ ونقدي. ما الذي أغواك للمشاركة؟ أمْ إنك في بداية
الطريق لا تريدين خسارة أي فرصة تعرض عليك؟
التوقيت أولاً. بعد فترة توقّف عن النشاطات الفنية
والثقافية، والعزلة التامة عن الناس، وما سبّبته كورونا من إحباط بعد تأجيل
أول دورة لـ"مهرجان
البحر الأحمر"،
أردت الشعور بالحياة وممارسة النشاط، وأنْ أكون في مكان تصوير، وأنْ أُخرج.
أحببت كلّ حلقة صوّرتها. ما أزال أحب الحلقات المنفصلة،
لأنها فرصة تجريب لا تتكرّر كثيراً. أخرجت حلقة دراما اجتماعية، وثانية
كوميديا سوداء، وثالثة تشويق، ورابعة فانتازيا. لو أقبل كلّ ما يُعرض عليّ
لما توقّفت يوماً عن العمل كمخرجة، لكنّي مُقلّة جداً.
"ممنوع
التجوّل" تجربة جميلة، مُمتنّة لها. عملت مع فنانين كبار، كناصر القصبي
وراشد الشمراني وعبدالإله السناني.
أترغبين في إخراج أعمال بوليسية؟ مسلسل "وساوس" على
"نتفليكس" يشي بذلك.
صغيرةً، كنت أعشق الروايات البوليسية. قرأت كلّ الروايات
المترجمة لأغاتا كريستي التي حصلت عليها. حقيقةً، أحب هذا النوع من الأعمال.
أكثر لقطة ساحرة في فيلم "شكوى" تلك التي تتلامس فيها مشاعر
الابنة وأبيها عندما يُمسك بيدها. كأنّه يتعلّق بها كطفل، أو يطلب منها
المغفرة.
إنّها أهم ما فيه. كنت أتساءل في كتابة
السيناريو:
"ما
الذي يجعل مشاعر شخص تتغيّر تجاه آخر، خاصة إذا كان الجرح عميقاً ومن
الماضي. ما الذي يجعل الإنسان يغفر؟ وبأي طريقة؟". اللحظة التي لمست فيها
البطلة العنود قرباً من أبيها، وشعرت بأنّه يُحسّ بألمها، انطفأ غضبٌ جامح
في أعماقها. في الكتابة، تردّدت على مستوصف لمراقبة موظّفات الاستقبال
بالنقاب، فشعرت بأنّ خلف النقاب قصة. لذا، لا شعورياً، ظهرت العنود ترتدي
النقاب بمستوصف طبي صغير. تخيّلت أنّها حُرمت فرصة أنْ تكون طبيبة، أو
بمؤهّل أعلى، بسبب غياب الأب عن البيت. هذا شائع في بيوت كثيرة أعرفها.
يغيب الأب، ويترك أبناءه من دون أي تفكير بهم. ربما يعود، إذا تبدّلت
أحواله، وربما لا.
هناك لحظات صمت طويلة للبطلة، يُفترض بها التعبير عن مشاعر
استبطانية مختلطة تجاه والدها. ألم تقلقي من لحظات التعبير الجواني من دون
كلمات، في مجتمع سينمائي وليد؟
أبداً. أعرف أنّ المسألة تعتمد كلّها على فهمي الحالة
وشرحها للممثلين. حذّرني أصدقاء أنّي كتبت نصاً يعتمد على أداء، وأنّه يصعب
حالياً العثور على من يؤدّي هذا الدور. ظلّ المشروع في الأدراج لمدة عام.
عندما شاهدت إبراهيم الحساوي في "عايش" لعبد الله العياف، عرفت أنّي عثرت
على أبو العنود، وأنّ الفيلم سيُنجز.
شعرت بأنّ اللحظات الخالية من الحوار الناطق جعلتك تفكرين
في التعويض بالموسيقى لتعزيز الشحنة العاطفية.
الموسيقى وزوايا التصوير والتفاصيل الأخرى غذّت الحالة.
مشية العنود مثلاً من المطبخ إلى غرفة الجلوس كانت بطيئة لأنّها لا تريد
ذلك. هناك تفاصيل مكتوبة في السيناريو ظهرت كما كُتبت. هناك أمور خارجة عن
إرادتي تعاملت معها كما كان ممكناً. مثلاً: اعتذر أصحاب المستوصف عن التصوير فيه.
المشاهد مكتوبة بتفاصيل تعتمد على ذلك المكان. أيضاً اعتذر البعض عن أداء
أدوارهم في اللحظات الأخيرة، لظروفٍ طارئة.
تعمّدتِ عدم توظيف العودة إلى ماضي الأب عبر "فلاش باك"،
مكتفية بلمحة عن هذا الماضي بلسان الأم. لماذا هذا الخيار السردي؟
الـ"فلاش باك" يُعد دائماً ضُعفاً في السرد، ما لم يُوظّف
بما يجعل القصة تمضي إلى الأمام. الماضي هنا خلفية للقصة، فلم أجد ضرورة
له. لديّ وقت محدود للتصوير، ولم أجد أنّ القصة تحتمل ذلك. الألم العاطفي
للعنود بسبب هجر الأب مدة طويلة، وليس فعلاً مُحدّداً بذاته قدر تراكم
الأفعال، وامتداده في الماضي.
في "أغنية البجعة"، تمثيل أسامة القس، هناك تطوّر واضح في
مستوى النص المكتوب، ما منح الممثل قدرة على تجسيد مشاعر جوّانية مختلطة
ومختلفة. يبدو لي أنّك فيه اكتسبت الخبرة في الكتابة. استندتِ إلى نصّ
مسرحي لتشيخوف أثرى السيناريو. هذا لا ينفي دورك في صقل الفكرة، وتحديد ما
تريدين من النص الأصلي، والاشتغال عليه. متى قرّرت العمل عليه، ولماذا؟
قبل كتابته، كتبت نصاً مسرحياً بعنوان "قاط وقاط"، مستوحى
من كتاب "أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب" لعبد الكريم الجهيمان. كنت أحضر
بروفات المسرحية لمخرجها أسامة القس. فتنتني حالة الممثل المسرحي، وكيف
يتجلّى الجميع على خشبة المسرح،
ثم يخفت الألق بابتعادهم عنها.
أحبّ المسرح كثيراً. واظبتُ على حضور مسرحيات كثيرة في
أدنبره، حيث أعددت الماجستير. فكّرت: ماذا عن الممثلين المسرحيين الكبار في
السنّ، الذين لم تتح لهم في السعودية فرصة الاستمرار في حب المسرح بسبب
ضغوط اجتماعية وحالة فنية في الماضي. أردت كتابة فيلم قصير عن هذه الحالة.
طلبت من القس حينها أن يكون الممثل، لأنّه مسرحي. تفاعل معي فوراً، وتحمّس
للفكرة. بدأت البحث عن مسرحية يمكنه أنْ يُمثّل فيها شخصية الممثل/
المدّرس، وتُعبّر عن حالته. عثرتُ على مسرحية تشيخوف، الذي أحبّ قصصه
كثيراً. بدأت العمل على النص، والتعديل عليه في البروفات مع أسامة. عملنا
على البروفات حتى ظهور الفيلم بصورته النهائية. لذا، كان الإهداء إلى
المسرحي الراحل محمد العثيم، لأنّه كان يُعبّر عن جيل من المسرحيين لم
يستطع تقديم المسرح الذي يحبّ.
يبدو لي كأنّك وضعت نفسك أمام تحدّ: صنع فيلم من لقطة
واحدة، مدّتها 17 دقيقة تقريباً. هل كنت تريدين إثبات أنّ موهبتك لا تقلّ
عن المخضرمين، أم إنّ هناك غرضاً يخدم الدراما؟
كان ضرورياً التعبير عن الحالة المسرحية لأنها عالم الفيلم
وعالم الشخصية. التقطيع سيُخلّ بالحالة. لذا، بعد تفكير، قررت إخراج العمل
بلقطة واحدة. هذا الخيار متناغم مع ما أريد التعبير عنه. المسرح يُعبّر عن
الآنية، واللقطة الواحدة أقرب تعبير عن هذا.
الفيلم لقطة واحدة مونودراما،
تتبدل فيها أحوال البطل: ممثل مسرحي سابق ترك التمثيل، وعمل مُدرّساً
للرياضيات، ليتزوّج حبيبته ويُرضي أهلها، ولأنّ التمثيل المسرحي نفسه، خاصة
الهادف، لم يعد يُطعِم. الأهمّ أنّك، في هذه اللقطة، كشفت عن ازدواجية
العالم العربي بأسره، ونظرته المتناقضة إزاء فنّ التمثيل، إذْ يستمتعون به
لكنّهم لا يحترمونه. متى وكيف ولد لديك هاجس عدم احترام فنّ التمثيل رغم
الإعجاب والاستمتاع به؟
في بروفات "قاط وقاط"، كنت أسمع كلاماً كثيراً عن معاناتهم
في العمل. آنذاك، كنت أعمل في شركة إنتاج المسرحية، فطلبوا مني أنْ ألتمس
من الإدارة تفريغهم لعمل ثقافي، وألا أقول فني أو مسرحي. في تلك الفترة،
كنت أجادل طويلاً كثيرين حول الفن، وما أزال، وإن توارت الحدّة نوعاً ما.
لا تزال هناك تفرقة بين الثقافي والأدبي والفني، ولا يزال الفن لا يُعتَبر
جزءاً من الثقافة بالمعنى الشعبي. أعتقد هذا دورنا كفنانين. بالنسبة إليّ،
جزءٌ من الفيلم يُعبّر عني أنا أيضاً، الفنانة التي تمارس فنّاً لم يُنظر
إليه بتقدير إلا أخيراً، ولا يزال هناك فاصل بينه وبين أشكال الثقافة
التقليدية الأخرى.
هل تطوير النص وتكثيفه بكلّ هذه الشحنة من العواطف والمشاعر
المختلطة سهلٌ؟
عدّلت كثيراً في النص بناء على البروفات. كنت أختبر كلّ شيء
قبل بدء التصوير. لم يكن الفيلم ليظهر كما ظهر لولا حماسة أسامة القس. كنت
حريصة على أن يكون هو الممثل، لأنّه من محبّي المسرح، ويفهم تماماً كلّ
كلمة في الحوار، ويتوحّد بها.
هل أُعيد التصوير كثيراً؟
أكان هناك إعدادٌ له؟
الإعداد للتصوير يتطلّب وقتاً ليحدث كلّ شيء بسرعة. قلتُ
لمدير التصوير إنّ العمل سيكون أشبه برقصةٍ بينك وبين الممثل. لا بُد من
الانسجام التام. أعدنا اللقطة 27 مرة، وآخر لقطة صُوِّرت نحو العاشرة
ليلاً. بدأنا التصوير في الصباح. قبله بيومين، أجرينا بروفات تقنية.
توظيفك للموسيقي هنا أكثر جرأة من "شكوى". هنا، اختفت
الموسيقى، أو لم تظهر طويلاً، تتوارى أو تخفت، مما يشي بإيمانك بأنّ أداء
الممثل لا يحتاج إلى الموسيقى أحياناً.
حضور الممثل هنا أهم، وعلى الموسيقى ألّا تطغى عليه.
بالتأكيد اكتسبت خبرة أكبر. أخرجت بعد "شكوى" حلقتين منفصلتين لمسلسل "بدون
فلتر". كنتُ أكثر وعياً بما أريده، وكيف أصل إليه. |