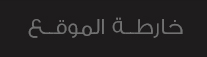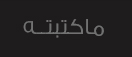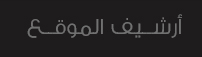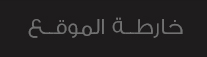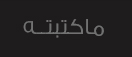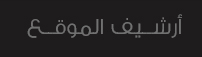|
زياد الرحباني ابن لبنان الضال وصوتُ لعنته
جاء بلغة جديدة وأتقن هجاء الهويات الراسخة
محمد أبي سمرا
وضع زياد الرحباني (1956- 2025) حياته الشخصية والعامة
ومواهبه الفنية في مهب الأهواء التي عصفت ببلده لبنان وأهله وبالشرق الأوسط
تاليا، منذ هزيمة 3 دول عربية في حرب 5 يونيو/ حزيران 1967. كان لا يزال
طفلا أو فتى بريئا آنذاك، وابنا لفيروز (نهاد حداد: 1935) وعاصي الرحباني
(1923- 1986). وهما، إضافة إلى منصور الرحباني (1925- 2009)، الأركان
التأسيسية الثلاثة للمؤسسة الفنية اللبنانية الأشمل، الأقوى حضورا وفاعلية
وتأثيرا في أجيال متلاحقة بلبنان المعاصر ومحيطه العربي.
الصرح الفيروزي الخالد
فمنذ مطلع خمسينات القرن العشرين، وحتى عام 1975، قامت تلك
المؤسسة الفنية بتجديد الفنون الشعبية والفولكلورية المشرقية: من أداء
غنائي وإيقاعات موسيقية ولحنية، إلى كلمات أغان أخرجها الرحبانيان من تقليد
شائع إلى تعبير شعري محدث. وهما وضعا هذا كله في إطار مسرح غنائي استعراضي
متجدد لصوت فيروز القمري الفريد ونجوميتها المتسامية على الأرضي والدنيوي
إلى الطيفي والضبابي. واستمر الثلاثة طوال ربع قرن من السنوات في تشييد
عمارة متكاملة من الصور الطوباوية الزاهية للبنان، بوصفه بلدا قمريا من
ضباب وغمام ونسائم وينابيع وبيوت على تلال وادعة... للألفة والسهر والحنين
والرجاء والمحبة والخير والعطاء والجمال والبراءة.
وساكنت صور لبنان تلك صدور ومخيلات وكلمات ومشاعر وانفعالات
أجيال من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وصولا إلى المغرب واليمن،
فعبدوها عبادتهم لصوت فيروز القمري الحزين حزنا شفيفا مواسيا وممزوجا
بالرضى وبطيف من فرح العيش في الطبيعة الريفية البريئة.
لم يتداعَ الصرح الفني الرحباني - الفيروزي وصوره في مخيلة
اللبنانيين مع بدايات تصدع الوئام الأهلي الطائفي اللبناني في 1969. وحتى
في سني الحروب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) بقي ذاك الصرح معينا ومنبعا
لحنين اللبنانيين الأليم الذي لا ينضب لبلدهم الفيروزي المعبود في صوت
"سفيرة لبنان إلى النجوم". وظلت فيروز بصوتها وبطقوسية حضورها النجومي
الأيقوني، تجسد لبنان القمري ذاك الذي يوحد آلام اللبنانيين وأحلامهم فيما
هم يحتربون ويقتتلون، وحتى اليوم، فيما فيروز التسعينية تودع ابنها البكر
زيادا إلى مثواه الأخير، بتجلد "أم يسوع الحزينة/وما من يعزيها"، على ما
يحب لبنانيون كثيرون القول، وكتبوا ذلك في تشييعهم زياد الرحباني.
والأرجح أن أحدا لم يتجرأ على توجيه سهام النقد التهكمي
اللاذع لمثل هذه الصور - وهي من صور الطوبى اللبنانية في الفنون الرحبانية
الفيروزية - قبل الرحباني الابن الضال، سليل الركنين الأهم في بناء صرح تلك
الطوبى الزاهي، والناشئ في كنف البيت الذي وضع أنغامها وألحانها وكلماتها
وصورها ولوحاتها المسرحية الاستعراضية طوال الربع الثالث من القرن العشرين،
وعايشها وخبرها على نحو يومي حميم، فيما هي تُصنع، وقبل فراره منها شابا
إلى تعبير فني آخر يناقض مشروع أهله الفني المتحقق.
الأرجح أن أحدا لم يتجرأ على توجيه سهام النقد التهكمي
اللاذع لمثل هذه الصور - وهي من صور الطوبى اللبنانية في الفنون الرحبانية
الفيروزية - قبل الرحباني الابن الضال
لقد فر زياد الرحباني سئما من ذاك الكنف العائلي ومن الطوبى
اللبنانية التي صنعها أهله، ولجأ في العام 1976 إلى كنف ما كان يسمى آنذاك
"الحركة الوطنية اللبنانية" اليسارية والعروبية في بيروت الغربية. وهو ترك
خلفه ما كان يسمى بيروت الشرقية المسيحية، التي وُصفت في الغربية باليمينية
والانعزالية. حدث ذلك بعدما اكتمل انقسام لبنان كتلتين أهليتين كبيرتين،
مسلمة ومسيحية، وارتسمت بين مناطقهما خطوط تماس ومعابر حربية كثيرة.
وكان سبق زيادا في فراره من هناك، شيوعيون وقوميون سوريون
كثيرون إلى غرب بيروت. أما من مكث من أمثال أولئك المحازبين المسيحيين في
ديارهم وبين أهلهم، فقد ارتضوا الصمت والانطفاء على هوامش المجتمع المسيحي
المتجهة نحو التجانس الطائفي، حيث سيطرت الميليشيا المسيحية المحاربة، في
مواجهة ميليشيات فوضوية كثيرة محاربة في مناطق الأكثرية الإسلامية.
الابن المدلل لأهله ولبنان
قبل ذلك، أي في النصف الأول من السبعينات، كان الرحباني
الابن ألِف في فتوته الفنية واستطاب الإقامة الموقتة ببيروت قبل انقسامها
الحربي إلى بيروتين. أقام آنذاك شهورا، وأقله لمرتين في تلك السنوات،
بمنطقة رأس بيروت الكوزموبوليتية منذ نشأة الجامعة الأميركية فيها. آنذاك
كان زياد الرحباني لا يزال ابنا مدللا للعائلة الرحبانية وللبنان تاليا.
وعلى المنوال الفني الرحباني - الفيروزي نسج عمله المسرحي الأول "سهرية"
(1973)، وعرضه لأشهر على مسرح سينما أورلي برأس بيروت.
أما عمله الثاني "نزل السرور" (1974) الذي عُرض أيضا في
المسرح نفسه، فخالفت فكرته الأساسية المسرح الرحباني، وأرهصت ببدايات
النزاع اللبناني. وغنى صديق الرحباني الابن الشاب، جوزيف صقر (1942 - 1997)
خريج المسرح الرحباني - الفيروزي، الأغنية الشهيرة التي ألفها ولحنها زياد
لتلك المسرحية وقال فيها: "كنا بأحلى الفنادق (كناية عن لبنان الجميل)/
جرجرونا ع الخنادق". لكن تلك الكلمات لم تُحمل على محمل الجد، بل أثارت
موجات من الضحك والتصفيق. وكانت الحساسية الطبقية ظهرت بطابع فولكلوري لدى
زياد في عمله المسرحي الأول، في أغنية صقر الشهيرة أيضا: "الحاله تعباني يا
ليلى/ خطبة ما فيش/ أنتِ غنية يا ليلى ونحنا دراويش".
عوامل كثيرة أدت إلى فرار الرحباني الابن من ديار أهله:
منها حياته البيتية والمدرسية ومنها مزاجه الشخصي الفني المتمرد والحر
لكن نمط العيش في رأس بيروت كان جذب زياد الرحباني طوال
النصف الأول من السبعينات، حينما كان أهله يقدمون عروضهم المسرحية في شهور
الشتاء من كل سنة في مسرح "قصر البيكاديلي" بشارع الحمراء. وبرزت موهبته
الموسيقية آنذاك في تلحينه أغانٍ لبعض تلك العروض، قبل أن يصير "ابنا ضالا"
في بيروت الغربية ابتداء من العام 1976.
المشاكسة والتمرد
عوامل كثيرة أدت إلى فرار الرحباني الابن من ديار أهله:
منها حياته البيتية والمدرسية التي روى بعضا من شذراتها في مقابلات
تلفزيونية. ومنها مزاجه الشخصي الفني المتمرد والحر. وكذلك الضيق والانتظام
الخانقان اللذان أطبقا على حياته ومزاجه في بيئته الأهلية والطائفية في
بدايات الانقسام الحربي اللبناني.
وهذا في مقابل ما كان خبره من رحابة الحياة وسيولتها
وتنوعها في رأس بيروت ما قبل الحرب. وبلغت الرحابة والسيولة حد الفوضى
الهاذية في الشطر الغربي من العاصمة اللبنانية المنقسمة في حرب السنتين
(1975- 1976)، عندما حل زياد الرحباني وأقام في رأس بيروت ابنا ضالا هاربا
من ديار أهله، طلبا للحرية والتمرد.
والأرجح أن هذه العوامل طبعت شخصية زياد الحياتية والفنية:
ابن ضال ومشاكس بلا هوادة ولا توقف أو عودة أو توبة. وربما ساعده في ذلك،
إلى مزاجه التكويني وانقلابه عليه، كونه الابن البيولوجي والفني لركني
المؤسسة الفنية والثقافية والرمزية الأوسع تأثيرا ونفوذا في تشكيل صورة
لبنان المعاصر، على الصعيد الرسمي وفي المخيلة الشعبية. وهذا إضافة إلى أنه
ابن فيروز، أيقونة لبنان شبه المقدسة في هذه المخيلة. وهو التقى كثيرين من
أمثاله وأشباهه في غرب بيروت "الحركة الوطنية" اليسارية والعروبية، والتي
شرعت في تكوين ثقافتها ونتاجها الفني اليساري الجديد، في مواجهة ما سمته
"الثقافة الانعزالية" اللبنانية في المناطق المسيحية ببيروت الشرقية.
والحق أن بيروت الشرقية كانت خالية تقريبا من الحياة
الثقافية والفنية التي كان غرب بيروت ومنطقة رأس بيروت وشارع الحمراء
مسرحها ومركزها منذ مطلع الستينات. فدور السينما والمسارح والترفيه،
والصحف، ومقاهي الرصيف، ودور النشر، كانت كلها تقريبا في رأس بيروت، شأن
تجمعات المثقفين والصحافيين والكتاب والفنانين التشكيليين والسينمائيين
والممثلين الذين كانت لقاءاتهم ونشاطاتهم تلتئم هناك. وظلت رأس بيروت على
هذه الحال طوال سنوات الحرب.
بلغته المفككة والنزقة بعريها من الإنشاء الخطابي والبطولي
تصدر الرحباني الابن الضال مشهد الكلام اليومي في لبنان كله تقريبا
كانت بيروت الشرقية "صحراء ثقافية" في زمن الحرب، قياسا بما
حصل في غربها. ففضلا عن تمركز الحياة والأنشطة الثقافية والفنية في غرب
العاصمة، لم يكن إنتاج "ثقافة بديلة" يحظى باهتمام الأحزاب والميليشيات
التي سيطرت على بيروت الشرقية. وهي كانت تنفر أصلا من التيارات الثقافية
والفنية الجديدة وتعتبرها، على نحو شبه هستيري، مخربة للثقافة اللبنانية
التقليدية الصافية. هذا فيما صرفت اهتمامها على التنظيم والتأطير وتأمين
الخدمات والجبايات المالية... وصولا إلى "توحيد البندقية المسيحية" تحت
لواء قيادة واحدة، تصدرها بالدم والمقاتل قائد "القوات اللبنانية" الشاب
بشير الجميل.
على خلاف ذلك تماما كانت حال بيروت الغربية في زمن الحرب:
عشرات التيارات والميليشيات والمنظمات العسكرية المختلفة والفوضوية،
المتصارعة والموحدة شكليا في إطار فضفاض تتصدره منظمات المقاومة الفلسطينية
وأحزاب "الحركة الوطنية" اليسارية والعروبية بقيادة القطب السياسي الدرزي
كمال جنبلاط وزعامته. وكانت هذه القوى والمنظمات والميليشيات تحظى بمداخيل
مالية خارجية مهولة للقيام بأدوارها الحربية والإعلامية والثقافية. هذا
فيما كانت جموع من المثقفين والشعراء والصحافيين والفنانين العرب الفارين
من بلدانهم، حطت رحالها في بيروت الغربية.
سحر الفوضى والهذيان
في ذلك المناخ الفوضوي وجد زياد الرحباني ضالته وحريته
الثقافية والفنية واللغوية في رأس بيروت وشارع الحمراء. فبدأ نشاطه ببرامج
إذاعية في إذاعة لبنان الرسمية التي سيطرت عليها أحزاب الحركة الوطنية، ثم
في "صوت الشعب" التي أنشأها الحزب الشيوعي اللبناني الذي راق للرحباني
الابن الضال الانتساب إليه والعيش في صحبة مثقفيه وكوادره. وسرعان ما اكتشف
المستمعون إلى هاتين الإذاعتين صوتا ولغة جديدتين تماما، ويتحدث إليهم
صاحبهما عن أحوالهم وحياتهم اليومية المباشرة وهمومها في زمن الحرب والقتل
اليومي، ساخرا من لبنان الطوبى وصورها وثقافتها التي كانت محض عمارة هشة
خلبية ووهمية، فهوت كصرح من خيال مزقه الرصاص ولطخته الدماء.
وبلغته المفككة والنزقة بعريها من الإنشاء الخطابي والبطولي
في برنامجيه الإذاعيين "بعدنا طيبين قولوا الله"، و"العقل زينة"، تصدر
الرحباني الابن الضال مشهد الكلام اليومي في لبنان كله تقريبا، تأييدا له
ونفورا منه، في أوساط وبيئات مختلفة ومتعارضة.
وسرعان ما انتقل زياد الرحباني من الإذاعة إلى خشبة المسرح
في رأس بيروت وشارع الحمراء، حيث قدم عروض أعماله المسرحية: "بالنسبة لبكرا
شو؟" (1978)، "فيلم أميركي طويل" (1980)، "شي فاشل" (1983)، "بخصوص الكرامة
والشعب العنيد" (1993)، "ولولا فسحة الأمل" (1994). وتصدر الرحباني الابن
وجوزيف صقر بصوته الغنائي الذي في منتهى الرقة والإلفة والحنان، المقام
النجومي في هذه الأعمال التي تجلت فيها موهبة الابن الضال في هجائه العبثي،
الهاذي والسوداوي، نمط العيش والتفكير والتعبير في لبنان. وقد تساءل في
إحدى أغانيه: "هاي (هذه) بلد؟"، ثم أجاب "لأ مش بلد/ هاي أرطة عالم
مجموعين. مجموعين؟... لأ مطروحين... لأ مضروبين... لأ مقسومين... قوم فوت
نام... وصير حلام أنو بلدنا صارت بلد".
جدد شخصية فيروز الغنائية بارتجالات كلامه الغنائي النثري
وبألحانه وتأليفه وتوزيعه الموسيقيين المتجددين، وهو بذلك جدد العمر الفني
والنجومي لفيروز، فقربها من ذائقة جيل جديد
والأرجح أن اللبنانيين لم يطربوا يوما حتى أقصى الطرب،
مثلما أطربهم هجاؤهم أنفسهم على هذا النحو في لغة زياد رحباني المتدفقة
الهاذية، إلا في ما غنته أمه فيروز بلغة رحبانية معاكسة تماما، منشدة لبنان
حلم يقظتهم السعيد الذي تحول إلى كابوس أسود، بعدما كان "بين الله والأرض
كلام" و"صخرة عُلقت بالنجم... أعبدها" (في شعر سعيد عقل وصوت فيروز).
وفي قاع ذاك الهجاء الزياد رحباني الهذياني الثاقب في
سوداويته الموازية للواقع، والتي تطاول بلدانا عربية شتى اليوم، كانت تسود
صور لبنان الطوبى الرحبانية الفيروزية الزاهية، وتتحول إلى محض رماد. وربما
ما من أحد سوى الرحباني الضال امتلك هذه الغريزية اللغوية الشفوية المتدفقة
في تهفيت وتسويد أحلام اليقظة اللبنانية السعيدة في لغة الرحبانيين وصوت
فيروز الملاك السماوي.
النجومية المضادة
وطوال سنوات الحرب تصدر زياد الرحباني المسرح النجومي
للحياة الفنية في بيروت، وإلى جانبه السينمائي مارون بغدادي، وظاهرة "شعراء
الجنوب" اللبناني، ومارسيل خليفة مغنيا قصائد محمود درويش بنفس موسيقي
يستوحي بعضا من المدرسة الرحبانية.
لكن الرحباني الابن الضال أسس نجوميته على نفور من النجومية
التقليدية السائرة. وهذا ما جعلها نجومية مضاعفة في استلهامها تراث أهله
الفني، نقده والخروج عليه خروجا صارخا في سخريته وتهكمه منه، بنثر الكلام
المستل من وقائع الحياة اليومية ومفارقاتها.
ثم لم يلبث زياد الرحباني أن جذب والدته فيروز، أيقونة
لبنان الطوبى الساحرة، فجدد شخصيتها الغنائية بارتجالات كلامه الغنائي
النثري وبألحانه وتأليفه وتوزيعه الموسيقيين المتجددين. وهو بذلك جدد العمر
الفني والنجومي لفيروز، فقربها من ذائقة جيل جديد.
وفي مقالة عن فيروز في كلمات زياد، كتب أحمد بيضون أن "قمر
الصباح الباكر (الفيروزي، صار) يحكي بلايا السهرة" الزيادية. وذلك لأن
"البيت الذي كانت فيروز ترتبه فينا كل صباح (قد) تهدم". وهذا بعدما "ترك
زياد حضن أمه (وراح) يعلـمها كلاما لم يتعلمه منها" في البيت. |